كما هو الحال في جميع المناطق القاحلة، فإن قضية المياه بشكل خاص أخدت بعدا سياسيا في الشرق الأوسط. إذ أصبحت مشكلة رئيسية في فلسطين المحتلة وفي الجولان المضمومة، شاهدة على سياسة تل أبيب العنصرية منذ إشادة أولى المستعمرات. كما تبقى مسألة جوهرية في صلب كل المخططات العسكرية والاستعمارية الإسرائيلية.

إن الشرق الأوسط أرض قاحلة. وإذا اقتصرنا الحديث على المناطق الثلاثة (الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية) حيث مشكلة الماء تطرح بشدة، نستنتج أن الاستغلال الحقيقي للموارد لتلبية الطلب الحالي، قريب جدا، بل يفوق ما هو متوفر بالفعل. وهكذا، تجاوز استهلاك المياه عام 1994 في إسرائيل 2.000 مليون متر مكعب في السنة في حين أن الموارد المتجددة لا تتجاوز 1.500 مليون متر مكعب في السنة. وفي الأردن، ارتفع نقص المياه في عام 1999 إلى 155 مليون متر مكعب وتم ضخ المياه من حقولها الجوفية بنسبة 180 ٪. والحالة أكثر وضوحا في قطاع غزة الذي يستهلك موارده المتجددة بنسبة 217 ٪، مما يطرح مشاكل هامة سواء فيما يتعلق بجودة المياه التي تضخ من الحقول الجوفية أو بما هو آت مستقبلا في ظل خطر تجفيف هذه الحقول، والتي كثير منها لا يتجدد مطلقا.
عرض تاريخي للوقائع
لقد كتب رئيس المنظمة الصهيونية العالمية "حاييم وايزمان"، قبلا في العام 1919، إلى رئيس الوزراء البريطاني "لويد جورج" قائلا أن « المستقبل الاقتصادي لفلسطين بأكمله متوقف على إمداداها بالمياه اللازمة للري والطاقة الكهربائية». وتشمل الحدود المطلوبة، علاوة على فلسطين، كلا من الجولان وجبال حرمون في سورية، وجنوب لبنان والضفة الشرقية للأردن. كما كتب "حاييم وايزمان" بعد سنة واحدة من ذلك، في تشرين الأول 1920، إلى أمين عام وزارة الخارجية موضحا أنه : «لو كانت فلسطين محرومة من نهر الليطاني، و مرتفعات نهر الأردن ونهر اليرموك ، دون التطرق إلى الشاطئ الغربي لـ(بحر) الجليل (بحيرة طبرية) ، فإنها لا تستطيع أن تستقل اقتصاديا. ولن تكون لفلسطين ضعيفة وفقيرة أية فائدة لأية سلطة».
وفي 1941، أعلن د. "بن غوريون" : «علينا أن نتذكر أنه من أجل التوصل إلى ترسيخ الدولة اليهودية، سيتوجب ضم مياه نهر الأردن ونهر الليطاني داخل حدودنا». كان "بن غوريون" و"موشي دايان" منذ البداية من مناصري غزو جنوب لبنان حتى حدود الليطاني. وصرح "دايان" في عام 1954 أن : «الشيء الوحيد الضروري هو إيجاد ضابط (لبناني) حتى ولو كان نقيبا فقط... نستطيع إما إقناعه أو شراءه بحيث يعلن نفسه منقذا للشعب الماروني المسيحي. ثم يدخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان، ويحتل الأراضي اللازمة ويقيم فيها نظاما مسيحيا حليفا لإسرائيل. وسترفق الأرض في جنوب الليطاني بشكل كلي وكل شيء سيكون على أكمل وجه». وشهدنا ذلك، فالاجتياحات الأخيرة لجنوب لبنان خطط لها منذ زمن بعيد!
ولقد بدأت إسرائيل تستمد المياه من بحيرة طبرية منذ 1953 لري الساحل والنجف، دون استشارة سورية أو الأردن ، واقتطعت جزءا من مياه نهر الأردن، وتم تفعيل خط الأنابيب القومي (نقل المياه عبر الأقنية) في عام 1964 (باللون الأحمر في الشكل 1). فباشرت سورية والأردن حينئذ إقامة سدود على اليرموك والمحول على بانياس لحجز المياه في أعلى بحيرة طبرية وبالتالي منع إسرائيل من استنزافها. فاتهمتهما إسرائيل بالاعتداء عليها، فما كان منها إلا أن قصفت ورشات عملهم حتى اندلاع حرب الستة أيام .كما أن لبنان أيضا يتهم إسرائيل بضخ مياهه الباطنية من حوض نهر الحاصباني.
ولقد سمحت حرب 1967 لإسرائيل باحتكار موارد غزة والضفة الغربية والجولان. كما اجتاحت الدولة العبرية جنوب لبنان في 1978 وحولت بالضخ جزءا من نهر الليطاني حتى عام 2000، وهو تاريخ انسحابها بعد المقاومة الشرسة لحزب الله في المنطقة.
وأتاح ضم الجولان، المسمى بـ "قصر الماء"، التحكم بحوض تخزين مياه مرتفعات نهر الأردن، وترجم بطرد غالبية السكان (100000 نسمة)، مما سمح في الوقت نفسه لإسرائيل بتحصيل المياه التي لا تستهلك محليا.
في عام 1994، تم توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن مع تخصيص فقرة للمياه لم تكن في صالح الأردنيين. وانقطعت المباحثات فجأة من قبل "إيهود باراك" مع سورية التي تقترح التفاوض بشأن كل شيء، ولا سيما الماء، مقابل الانسحاب الكامل لإسرائيل من الجولان المحتل. أما بالنسبة لاتفاقات أوسلو عام 1993، في حال أقرت إسرائيل (رسميا) «حقوق الفلسطينيين بالمياه»، فسيستأنف التفاوض في المباحثات النهائية حول وضع الأراضي المحتلة...! ورفض المسؤولون الإسرائيليون، بما فيهم المعتدلون، مناقشة موضوع المياه في معاهدة جنيف...
السياسة الإسرائيليه في موضوع المياه
في العام 1936 إستوحى "والتر كلي لودرميلك" من الأعمال الجارية آنذاك في وادي "تينيسي" في الولايات المتحدة ليقترح إنشاء «سلطة وادي الأردن» تحت الرقابة الدولية. ونفذ قسم كبير من هذه الفكرة في خطة جونستون بشأن وادي نهر الأردن، باسم مبعوث الرئيس الأمريكي "أيزنهاور" ، من اجل إحداث سلطة إقليمية في 1954-1955 ، تقوم على مشاركة بيدولية للدول المشاطئة لنهر الأردن ، تهدف إلى تخصيص وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل.
القانون الإسرائيلي عن المياه
لكن إسرائيل شاءت أن تأخد الأمور منحا آخر. فلقد جعل قانون المياه في إسرائيل عام 1959 من الموارد المائية «ملكية عامة ... خاضعة لسيطرة الدولة». وعدل بشكل كبير المحتوى الشرعي والقيمة الاقتصادية والاجتماعية للملكية العقارية وللموارد التي يحويها القانون. هذا يقدم لنظام يمنع الفلسطينيين من التصرف بحرية بمواردهم المائية، مؤسسا لتمييز منهجي واضح. لكن السياسة المتبعة منذ عام 1967 في غزة والضفة الغربية هي ذات خطورة من نوع آخر. فقد تم اتخاذ إجراءان مهمان منذ الأيام الأولى لغزو الضفة الغربية وغزة في عام 1967 :
1 – حظر أي بنية تحتية مائية جديدة وحفر آبار تلو آبار بدون إذن.
2 – مصادرة الموارد المائية المعتبرة ملكا للدولة وفقا لقانون المياه الإسرائيلي لعام 1959 الذي أمم المورد.
ولقد استخدمت إسرائيل، وبإفراط ، مراسيم عسكرية عدة لكي تتمكن من تطبيق قانونها بخصوص الموارد المائية. كما تجلى التمييز بالأساس في العقبات المفروضة على حفر الآبار. وينشط حاليا 350 بئرا فلسطينيا في الضفة الغربية، يمثل 23 منها 6،5 ٪ من مجموع الآبار، وهي محفورة منذ بدء الإحتلال لخدمة مصالح المستعمرات الاستيطانية. ويتطلب حق حفر آبار جديدة ترخيصا، ويترك لتقدير السلطات الإسرائيلية. كما فرض نظام الحصص منذ 1975، ويجر تجاوزه إلى غرامات باهظة (وفق عدادات تم تركيبها). إلا أنها ازدادت أربع مرات... وجمدت كمية المياه المتاحة للمزارعين في الضفة الغربية منذ 1967 : وحدد السقف ب 90-100 مليون متر مكعب سنويا لـ 400 قرية. وعلى العكس ، فإن كمية المياه المخصصة للمستعمرات اليهودية ازدادت بنسبة 100 ٪ خلال السنوات 1980.
استخدام «قانون الغائب»
تحت ذرائع أمنية، تم تعزيز «قانون الغائب» بالإعلان عن «مناطق أو قطاعات خاصة». استولت إسرائيل على هذه الأراضي وفقا للقانون العسكري المطبق على «الملكية المهجورة»، مصادرة بذلك عددا مجهولا من الآبار التي كان يستخدمها الفلسطينيون الذين تعرضوا للتهجير الجماعي عام 1948، واعتبروا «غائبين». كما أن التشريع الإسرائيلي يخضع بعض مناطق الضفة الغربية إلى أنظمة معززة : «المناطق التي تخضع للتقنين»، «مناطق الصرف»، «مناطق الأمن العسكري». وهذا حال مجموعة أراض على طول نهر الأردن ، المعلن عنها « مناطق عسكرية» ، والتي يستخدمها الفلسطينيون لغايات الري. وتحد هذه الإجراءات بشكل كبير من وصول الفلسطينيين إلى المياه التي يشتريها المزارعون الفلسطينيون لاحتياجات الري بثمن باهظ – وخاصة مياه الشرب –.
وقبل عام 1967، كان السكان الفلسطينيون يجهلون هذه الممارسة : بالنسبة للضفة الغربية، كانت السلطة الأردنية تطبق التصاريح المتعلقة باستخدام المياه عموما . أما في قطاع غزة ، فلم يكن يوجد أي نظام ترخيص قبل عام 1967، وكان استخدام المياه يقوم على القانون المتعارف عليه. وهكذا، إنتقل قانون منح تراخيص لاستخدام المياه من سلطة مدير السجل العقاري الأردني إلى السلطات الإسرائيلية وفق القوانين العسكرية رقم 450 و 451 لعام 1971. ووفقا لمصادر مختلفة ، منحت من 5 إلى 10 تراخيص منذ عام 1967. وكذلك خضع إصلاح وتنظيف الآبار، منذ 1975، لأذونات إسرائيلية عمليا غير موافق عليها على الإطلاق. وقد أقرت إسرائيل سياستها في تحديد تراخيص جديدة للفلسطينيين تحت ذرائع توفير المياه وتحسين أساليب الري لإتاحة زيادة إنتاجية الزراعة المحلية...!
شركة الميكوروت
لقد تم التأسيس لهذه الممارسات التمييزية : حيث سيطرت الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية وااـصندوق القومي اليهودي على الميكوروت (شركة إسرائيلية للتسيير) والتاهال (شركة تخطيط الموارد المائية لإسرائيل)، وهدفهم المشترك هو الدعم الحصري للمصالح الإسرائيلية. يضع تكامل الخدمات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية في حالة من التبعية القانونية والإدارية وذلك بفرض مركزية هذه الشركات وإلغاء مساهمة السكان المحليين.
وطورت شركة ميكوروت منذ عام 1967 شبكات لصالح المستعمرات بشكل شبه حصري. وأهمل تطوير وصيانة أنظمة البلديات الفلسطينية، بينما كانت شركة الميكوروت تسيطر وتوسع شبكة توزيعها. وفي القطاعات الفلسطينية التي تنشط فيها ميكوروت، فإن وضع التخزين سيئ جدا لدرجة أن 40% من المياه التي تنقل إلى الضفة الغربية تهدر على الخط. وبقي النظام المائي الفلسطيني على حاله منذ 1967. وترتفع هذه الخسائر إلى 60 ٪ في طولكرم ، و20 ٪ في رام الله. وسبب إحداث البنى التحتية المائية، التي تربط بين المستعمرات الاستيطانية فيما بينها، في حصر الأراضي الفلسطينيي داخل تقسيم تربيعي صارم. والوضع لا يزال أكثر مأساوية في غزة حيث المياه الجوفية الساحلية المستغلة بإفراط تتسرب الآن من مياه البحر. أما بالنسبة لمستقبل الدولة الفلسطينية، فإن احتمال مضاعفة الشبكات المائية يبدو صعبا ومكلفا.
عدم المساواة في استغلال الموارد المائية وسعرها
إن وجود الموارد لا يكفي، بل يجب الوصول إليها، غير أن منع التجول والحصار المستمر يؤديان إلى حالات مأساوية. ويجبر تدمير الشبكات والخزانات على إحضار المياه في الصهاريج، ويزداد سعرها الذي يمكن أن يصل إلى 40 نيس للمتر المكعب أي (اكثر من 8 يورو) ، أي ما يقارب 10 أضعاف السعر المطلوب في البداية من قبل البلدية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وباعتبار خضوع الشبكات في أغلب الأحيان لسيطرة المستعمر المباشرة، فإن هدا الأخير يغلق صمامات توزيع المياه في اتجاه القرى الفلسطينية عندما يحلو له. وإذا كان الإسرائيليون ينعمون بالمياه الجارية طوال السنة، فإن الفلسطينيين هم ضحايا الحرمان التعسفي، وبخاصة خلال الصيف. أما بالنسبة للثمن الذي يدفعه المستهلك الفلسطيني، فهو من حيث المبدأ نفس السعر الذي يدفعه الإسرائيلي ، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي هو أعلى بنسبة 20 ضعفا في إسرائيل من الضفة الغربية. فقطاع المياه في المستعمرات اليهودية، في الحقيقة، مدعوم ماليا وبقوة، في حين أنه يجب على المواطن الفلسطيني دفع 4 أضعاف ما يدفعه مستعمر ليحصل عليها. وهكذا يمكن أن تصرف أسرة فلسطينية عدة مئات من الشيكل شهريا، في حين أن دخلها لا يتجاوز 1500 شاقل شهريا. (نيس 1 = 0.21 يورو = 1.37 فرنك فرنسي. 1 يورو = 4،7 شيكل).
وفي ظل ظروف كهذه، وبما أن إسرائيل هي وحدها التي تدير التدفقات المائية، فإن السلطة الفلسطينية للمياه، والتي أحدثتها اتفاقية أوسلو رقم 1 قبل أن تلغيها اتفاقية أوسلو رقم2، تبدو عديمة القيمة. فهي تستخدم خصوصا ككبش فداء لمواجهة استياء السكان الفلسطينيين. ولقد فقدت سبب وجودها بعد التدمير المنهجي للبنى التحتية (البراميل) واستحالة السيطرة على التلوث.
حالة أماكن المياه الجوفية وتوزيع المياه على المستهلكين
يعادل متوسط الاستهلاك السنوي للمواطن الإسرائيلي (357 متر مكعب) أربعة أضعاف متوسط استهلاك المواطن الفلسطيني من الضفة الغربية (84،6 متر مكعب). ويبلغ الاستهلاك المحلي لمواطن إسرائيلي ثلاثة أمثال ما هو عليه استهلاك الفرد الفلسطيني. والأمر بالنسبة للإستهلاك الزراعي أفظع بكثير، وتشجع سياسة الإعانات الإسرائيلية في الواقع استهلاكا مرتفعا للموارد المائية. وتروي المستعمرات 60% من أراضيها المزروعة مقابل 45% في إسرائيل و6% في الضفة الغربية، ما يشكل عائقا كبيرا أمام الزراعة الفلسطينية.
وتتيح التشريعات المشار إليها أعلاه لإسرائيل تلبية احتياجاتها من المياه بفضل التحويلات التي ترتبط باستلابات واقعية. (انظر الشكل 1 لما يلي).
– مكن غزو الجولان إسرائيل، منذ عام 1967، من التحكم ببانياس وكذلك المياه الجوفية ومجاري المياه التي تمر عبر الجبل وأن تعطيه شهرته قصر المياه. وتحمل الجولان لإسرائيل أكثر من250 مليون متر مكعب من المياه سنويا. كما يزود الجولان واليرموك قرابة ثلث مجمل الاستهلاك الإسرائيلي. وبالتالي ، فإن 75 ٪ من مياه نهر الأردن تحولها إسرائيل قبل أن تصل الأراضي.
– في الضفة الغربية، توفر ثلاثة طبقات مياه جوفية ثلثا آخر من الاحتياطات المائية لإسرائيل، التي تستهلك قرابة 86 ٪ من مياه المنطقة. ويستخدم الفلسطينيون من 8 إلى 12% منها، بينما يستهلك االمستعمرون الإسرائيليون من 2 إلى 5 ٪. بعد أكثر من ثلاثين عاما من الاحتلال، لا تزال نحو 180 قرية في الضفة الغربية غير مرتبطة بنظام التوزيع. وتكمن السيطرة على مصادر المياه في أيدي شركة ميكوروت الإسرائيلية التي توزع سنويا 110 مليون متر مكعب على 1،5 مليون فلسطيني (أي 73 متر مكعب للفرد)، و30 مليون متر مكعب على 140.000 مستعمر (أو 214 مترا مكعبا للمستعمر) ، بينما يذهب 460 مليون متر مكعب لإسرائيل. تطبق هذه الشركة توزيع المياه وتعريفات تمييزية أيضا. فتفرض على الإسرائيليين مبلغ 0،7 دولار للمتر المكعب للاستخدام المنزلي و 0،16 دولار للزراعة، بينما لا توجد أسعار تفاضلية للفلسطينيين الذين يجب أن يدفعوا 1،20 دولار للمتر المكعب. ومن حسن الحظ أن هذه الطبقة المائية تتجدد بسهولة بفضل وفرة الهواطل.
أما في غزة، فمساحة الأرض صغيرة في حين تبقى الهواطل ضعيفة. وحسب التقديرات فإن 35 مليون متر مكعب فقط هي التي تخترق الأرض لتصل طبقة المياه الجوفية. ونظرا لنمو عدد السكان (من 50.000 شخص قبل عام 1948، إلى 1،2 مليون اليوم، وهو ما يقابل 29 مترا مكعبا من المياه للفرد سنويا!)، فإن هذه الطبقة الجوفية تستغل بإفراط، حيث تتعرض 70 ٪ من مواردها لأضرار. يضخ الإسرائيليون بطريقة هامة جدا بالقرب من قطاع غزة ويستنزفون الآبار الفلسطينية حيث المياه المتوافرة فيها مالحة وملوثة أيضا.
لا يوجد نهر في قطاع غزة، لكن هناك وادي يجمع مياه عدة وديان في المنطقة. أقام الإسرائيليون سدودا صغيرة على هذه الوديان، والمياه الوحيدة التي تجري منذ ذلك الحين في وادي غزة هي المياه المستعملة وغير المعالجة من مدينة غزة... تلقى قطاع غزة ويتلقى بعض الدعم الدولي لحل أزمة المياه جزئيا (تحلية المياه واستيرادها ومكافحة التلوث)، لكن ذلك يبقى غير كاف قياسا إلى الطلب المحلي.
الآثار على البيئة
يمثل متوسط استهلاك الفلسطينيين للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، بجميع أوجه استخداماته، حوالي 150 متر مكعب لكل فرد سنويا، في حين أن المستعمرين في الضفة الغربية يستهلكون ما بين 700 و 800 متر مكعب. وهو ما جعل استهلاك المياه الجوفية يتجاوز حده. ومنذ احتلال الضفة الغربية وغزة، لاتستفيد 70 إلى 80 ٪ من المدن والقرى الفلسطينية من المياه إلا لبضع ساعات فقط في الأسبوع، مما يجبر السكان على تخزين الموارد المائية، حتى في ظل ظروف صحية خطرة ، بينما تحصل الفرق العسكرية الإسرائيلية والمستعمرات على تغذية 24 ساعة يوميا. فيعيش هؤلاء وكأنهم في بلد أوروبي، في حين أن السكان الفلسطينيين يقتصدون في استعمال المياه يوميا مدركين خطورة الجفاف الذي يهدد المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك فإن التطور الزراعي الإسرائيلي يجري في تناقض مع الموارد المائية المتاحة. فالفلسطينيون لا يملكون الحق في حفر الآبار، في حين يستطيع المستعمرون فعل ذلك وعلى أعماق كبيرة (300 إلى 500 متر). وهكذا ، فإن الفلسطينيين لا يحرمون فقط من حفر آبار جديدة دون موافقة عسكرية بل يحظر عليهم خاصة أن تتجاوز آبارهم عمق 140 متر ، في حين أن عمق آبار المستعمرين يمكن أن تصل إلى 800 متر.
تفاقم الوضع
لا يزال الوضع مترديا منذ الانتفاضة الثانية، إذ أن الجيش الإسرائيلي والمستعمرين يغزون الآبار بوثيرة شبه منتظمة، ويمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى المياه، ساعين على المدى البعيد إلى دفعهم للرحيل. ونتيجة لذلك، فإن تكلفة شراء خزانات المياه ازدادت بشكل كبير، حيث ارتفعت من 3 دولارات للمتر المكعب إلى 7 دولارات . وتقصف المروحيات الإسرائيلية الخزانات على أسطح المنازل وكذلك الآبار الهامة كما هو الحال في رفح.
طالب الفلسطينيون بمياه الطبقات الجوفية في الضفة الغربية مشيرين إلى أن إسرائيل تستغل آبارهم العميقة و 80 إلى 90 ٪ من الطبقات المائية التي ينبغي أن تعود إليهم، لأنها تقع تحت تلال الضفة الغربية. ويعتبرون أن الدولة الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف (التي تنص على الوضع الراهن للأراضي المحتلة) بحفر آبار لمستوطناتهم الخاصة، بينما تجمد الاستخدام الفلسطيني للمياه. ومن جهة أخرى فإن هذه الآبار قد تجفف الآبار الأقل عمقا في القرى التقليدية.
وتأتي المشكلة بالنسبة لغزة من الآبار المحفورة في طبقات المياه الجوفية. ووفقا لما أفادت به السلطة الفلسطينية، فلقد ضخ الإسرائيليون طبقات المياه الجوفية على الأطراف المباشرة من قطاع غزة، مما أدى إلى التملح الحالي للآبار.
ويضاف إلى ذلك 31 ٪ من المجتمعات الفلسطينية الغير مخدمة : فهي تجد نفسها غالبا محرومة من التغذية المائية، إما بسبب الصهاريج المجمدة في نقاط التفتيش، أو لأن المياه مالحة كما في غزة وفي المياه الجوفية الشرقية في الضفة الغربية، بما أنها مرهونة لشركة ميكوروت التي تفعل ما يحلو لها.
الدور الحقيقي للجدار العازل وسياسة ضم الأراضي
رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، باسم الأمن الوهمي والمزعوم، تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي أصدرت الأمر بالانسحاب إلى حدود 1967 المسماة بالخط الأخضر، وإعادة مرتفعات الجولان إلى سوريا. والحال أن سياسة «الأمر الواقع» ، التي تتبعها إسرائيل لرغبتها المعروفة في الاستيلاء على الأراضي (حلم "كبير إسرائيل التوراتي" لبعض قادة إسرائيل)، تهدف خصوصا إلى وضع اليد على 90 ٪ من موارد المياه في المنطقة، الأمر الذي يجب أن يكون فعالا عندما سيكتمل بناء الجدار. وهذه السياسة التي تخطط لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية باستنزاف منفذهم إلى مواردهم المائية الخاصة، من المتوقع أن لاتلقى إدانة دولية شديدة...
لنحكم على الأمر على أرض الواقع : يتبع مخطط الجدار منطقا مدروسا : الحد الأقصى من الأراضي والحد الأدنى من السكان، بقصد التوسيع المستقبلي للمستعمرات. ويتبع التصميم الأخير بعناية المستعمرات الرئيسية، لكنه يعمد أيضا للاستيلاء على أفضل الأراضي وللتحصيل الأمثل لمنافذ المياه. ويؤدي فصل الآبار عن الأراضي إلى جفاف هذه الأراضي أولا، وإلى خسارة الاستثمارات والمحاصيل ومن ثمة إلى الهجرة وبالتالي استيلاء إسرائيل على «الأراضي غير المزروعة» باسم «القانون».
ففي حزيران 2003 (انظر الشكل 2)، وفي مناطق قلقيلية وطولكرم على سبيل المثال، كان أكثر من 50 ٪ من الأراضي المروية معزولة وأكثر من 5 ٪ مدمرة، كما توجد 50 من أصل 140 بئرا و 200 صهريجا معزولة أو في المنطقة العازلة، ولقد تم تدمير 30 كيلومترا من شبكة الري و 25 بئرا وخزانا مخصصة لـ 51 بلدة ، أي أن أكثر من 200.000 شخص ، منهم 40 ٪ حاليا، يعيشون بدون موارد مائية.
ويشير أحد تقارير منظمة الأمم المتحدة إلى أنه تم تدمير 780 بئرا لتوفير المياه للاستعمال المنزلي والري بين 1993 و 1999، أي خلال فترة التوقيع على اتفاقيات أوسلو. أما بالنسبة للقطاعات، حيث أنه رغم كل ذلك، لا تزال فيها بعض المنتجات، مثل المعاصر في قلقيلية، فإن إغلاق طرق المواصلات يجعل من التسويق أمرا مستحيلا. وتتسارع سياسة الأبارتايد، المفعلة مسبقا في غزة منذ أكثر من 10 سنوات، مع تشييد الجدار في الضفة الغربية. وفي رفح، بقطاع غزة، حيث نفذ الهدم النظامي لمئات المنازل على أيدي جيش الاحتلال، تم تدمير البنى التحتية الأخرى من صهاريج وشبكات وخزانات المياه العامة. وهو حال محطة ضخ بئرين يزودان 50 ٪ من سكان المدينة بالمياه خاصة في بداية عام 2003. والبئرين هذين يوفران 6.000 متر مكعب من المياه يوميا (نوعية جيدة وليست مالحة) من أصل الـ13.000 متر مكعب التي تستهلكها 130.000 نسمة يوميا. وللإشارة فقط فإن أحد هذين البئرين تم حفره في عام 2001 من قبل السلطة الفلسطينية وبتمويل من الحكومة الكندية.
وفي آذار 2003، ومنذ بداية الانتفاضة الثانية، حددت الأضرار في الأراضي المحتلة على النحو التالي : 151 بئرا، 153 مصدرا للمياه، 447 خزانا، 52 صهريجا متنقلا (ناقلات)، 9.128 من خزانات الأسطح، 14 حوضا ، و 150 كيلومترا من مجاري المياه التي تغطي حاجيات أكثر من 78.000 منزلا.
المستقبل؟
إنه من غير المقبول أن تحتكر إسرائيل تقريبا مجمل الموارد المائية في المنطقة وأن تحصرها على مواطنيها الذين لايمثلون سوى أقلية الساكنة. أن تكون هذه الموارد غير كافية للسماح باستخدام المياه بشكل مماثل لما تعرفه البلدان المرفهة هو أمر لا يمكن تجنبه، لكن يجب أن يشجع على البحث عن تسوية مرضية لكافة شعوب المنطقة. إلا أن إسرائيل ترفض حتى يومنا هذا كل تفاوض حول هذا الموضوع مع السلطة الفلسطينية بقدر ما ترفضه مع جيرانها، وسياستها في جنوب لبنان والجولان خير دليل على ذلك.
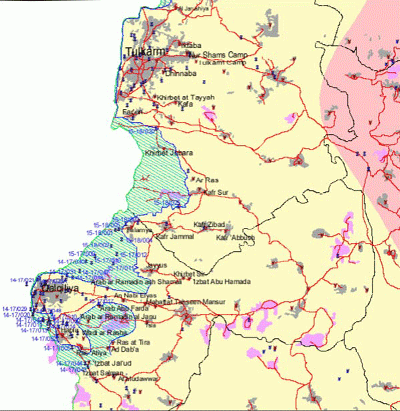
كما حجبت إسرائيل السياسة الدولية للمياه، والتي كانت قد بدأت أولى حلقاتها في سنوات الخمسينات مع خطة جونستون. وربما حان الوقت لعقد مؤتمر دولي لبلدان الجوار، برعاية منظمة الأمم المتحدة، مع الإدراك الكامل بأن التسوية السياسية على أساس قرارات الأمم المتحدة، والتوزيع المنصف للمياه أمران لا يمكن الفصل بينهما. ومن الواضح أيضا أن حل مشكلة المياه سيكون أسهل في حال أصبحت فلسطين بلدا واحدا علمانيا يتيح لجميع السكان العيش في ظل القوانين نفسها. في انتظار ذلك، سيقود الوضع الراهن لامحالة إلى كارثة معلنة. ولنتذكر أن حضارات إختفت في تاريخ بلاد ما بين النهرين نتيجة لعدم كفاية الموارد المائية حينها.
ترجمته خصيصا لشبكة فولتير: روعه الرقوقي
جميع الحقوق محفوظة 2007 ©






















